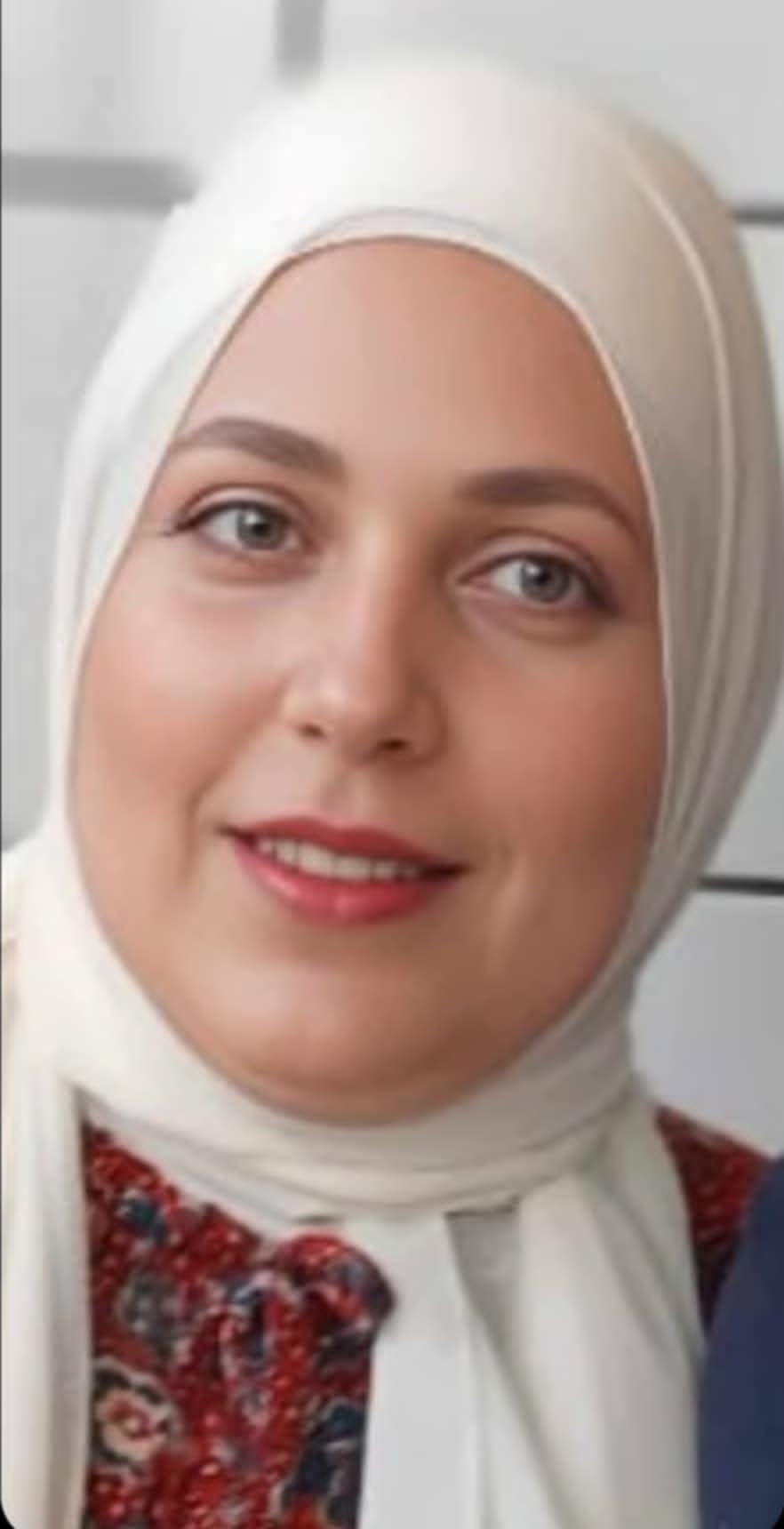حين يغيب الأحبة، نلهث وراء أي شيء يشبههم ويحيي الذكرى بداخلنا فيهبها من الحياة قبلة تنعش قلوبنا للحظات… صورة، فيديو، مقطع صوت، كلمة عابرة، رائحة عطر أو حتى ملمح بين اطار وجه غريب . فنحتضن هواتفنا وكأنها صندوق الأسرار الأخير، نعود إلى ما سجلناه — عمداً أو عفواً — وكأننا نحاول إعادة الحياة بنبضٍ إلكتروني، لكنه دائمًا ما يخوننا. فالصوت لا يُدفئ، والصورة لا تضم، والمشهد مهما كان حيًّا… لا يجيب.
وقد يتسلّل سؤال خافت:
لماذا لم يمنحنا الله أرشيفًا كاملًا لمن نُحب؟
أليس هو الأعلم بحاجة قلوبنا؟
لكنه، بلُطفٍ لا يُدرك في لحظة الحزن، ترك الأثر مزروعًا في الصدر، لا محفوظًا في جهاز.
فلو امتلكنا تسجيلًا كاملًا، لحبسنا أرواحنا في الغياب، ولصرنا أسرى الصورة، لا أحرار الذاكرة.
ان الرغبة في الاحتفاظ بذكريات من والي الأحبة لها وهج …وهج إن زاد أحرق
تتبدّل الغاية… ويصير التوثيق لنا لا لهم.
فنكتب ونُسجل ونُخطط لحضورٍ بعد الرحيل، خشية أن تُطمس أسماؤنا… فننشغل ببناء الذكرى ونُهمل عيش اللحظة.
بل نُبالغ في تشكيل الذكرى قبل أوانها، فلا نمنحها فرصة التكوّن بعفوية، ولا نترك للمحبة مساحتها النقية.
والأخطر… أن ما نُسجله قد يتحول لمحكمة بعد الرحيل.
نعود لاشتياقٍ لا لرحمة، بل لمحاسبة.
نُراجع الكلمات والمقاطع لا لنطمئن، بل لنحكم، والغائب لا يملك توضيحًا، ولا فرصة دفاع.
لحظة واحدة قد لا تمثّله، لكنها تدينه.
وهكذا، نُخطئ في الأثر ونظلم من نُحب… بغفلة لا بقصد.
ويشتد سرج الحزن حول أرواحنا، فلا مفر مما صنعناه اليوم.
فلعلّ أعظم ما يمكننا فعله: أن نعيش اللحظة لا لنُوثّقها، بل لنُحبها.
أن نغرس أثرًا لا مؤثرًا، ونحفظ حرمة الذاكرة فلا نحاكم بها أحدًا.
من نعم الله الخفية، أنه لم يمنحنا أرشيفًا دائمًا، بل وهبنا ذاكرة حرة… تتذكّر ما نحب، وتنسى — برفق — ما يؤلم.
أما التوثيق الكامل، فيصادر تلك الرحمة، ويحرمنا وأحبتنا من النسيان الشافي.
فالإنسان لا يبقى بأرشيف، بل بأثرٍ نقي في القلب… وذاكرة فيها حيّز للحنين، وآخر للنسيان.